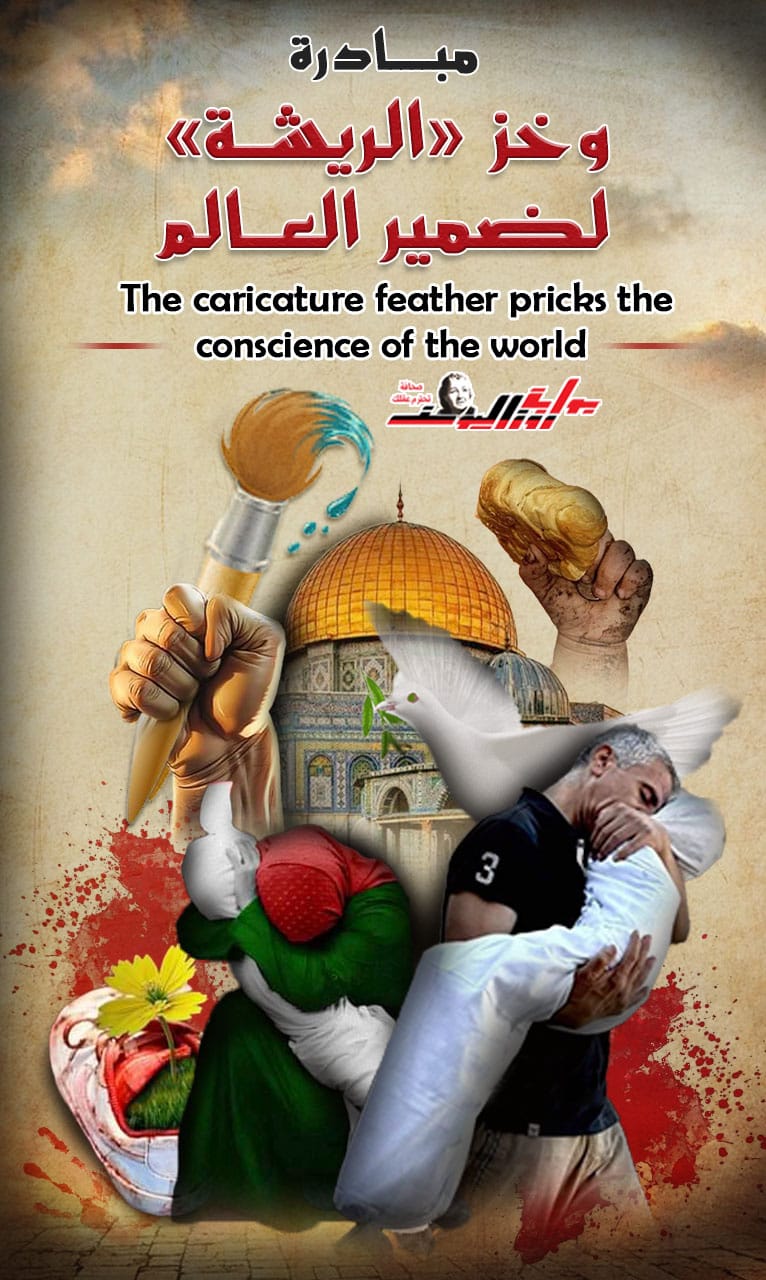غلاء سمير أنس تكتب: عن الحق في الانفعال

إحدى الظواهر الإنسانية التي تطورت في القرن الأخير، ونشهد اليوم ذروتها المُضنية للنفس، هي تلك "الكياسة" الاجتماعية التي يبديها المجتمع تجاه شتى الظواهر والأفعال والأحداث، فتتساوى جميعاً في نظره، وتُطرح جميعاً على طاولة النقاش بالمستوى ذاته، وتُمنح القدر ذاته من الأهمية، وتُرفع أسئلتها إلى المستوى ذاته من الجدية، ولا يسع المرء إلا أن يعجب من ذلك، وأن يرتفع ذلك السؤال المهم في ذهنه: أين فشِلنا بالضبط؟ ما المرحلة التي أخطأنا فيها لتتحقق لنا هذه النتيجة البشعة؟
هذا المقال مجرد تعبيرٍ عن النفس، ليس بالأكاديمي ولا أدعي فيه الإلمام بالموضوع الذي أتحدث عنه، إني أتحدث بما أريد فحسب.
يتحدث ريتشارد سينيت في كتابه العظيم "في مواجهة التعصب" عن ظهور الذات غير المتعاونة في المجتمع الحديث، أي تلك المنسحبة من الفضاء العام، والتي تختار عدم الانخراط في آليات التعاون المجتمعي – على قلتها – كآلية نفسية دفاعية تحفظ فيها نفسها من العطب والضرر، ويُرجئ ظهورها إلى التخفيف من الحصر النفسي Anxiety والانسحاب النفسي من الفضاء العام والرضا الذي يعقب الضجر ويركن إليه المرء والاستحواذ القهري الذي يمكن أن يُبتلى به المرء.
وفي الفصول السابقة لهذا الفصل – الذات غير المتعاونة – تناول الكياسة المتطورة في المجتمع الأوروبي والأمريكي، والتي عُدت نظاماً من المبادئ والقوانين المجتمعية التي تحكم الفرد وتضبط خصاله. وما يهمني هنا، إشارة الكاتب المستمرة إلى أمرٍ فكرتُ فيه مطولاً:
ما سر هذا البرود العام الذي يصيب الإنسان اليوم؟ كيف قُننت العاطفة وحُجم الانفعال ونُزعت منهما العقلانية والأحقية والجدارة؟ كيف سُلب الإنسان من حقه في الغضب والانفعال والصراخ، خاصة عندما يشير إلى ظاهرة بشعة أو حدث جلل؟
يقول سينيت: "وجد بيندكس أن العمَّال يقعان بين فكَّي كماشة، يحملون في رؤوسهم تصورات كيف يجب أن يكون عليه العمل الأكثر تحفيزاً، ولكنهم يحتفظون بهذه الأفكار لأنفسهم خشية أن يُشار إليهم أو أن يُعاقبوا بوصفهم "مثيري شغب"، يتقاسم هؤلاء بعد العمل أفكارهم على كأس جعة، لكنهم خلال العمل يضعون القناع ويبقون في حالة ازدواجية.
لقد ظهر القناع كسمة مجتمعية حديثة "تضبط" روح المرء الثائرة "وتعلمها" الكياسة المجتمعية و"الآداب" الحوارية، والتي لا مكان فيها للصراخ أو الانفعال، ولكن كيف تم الخلط بين هذين المفهومين بهذه السذاجة؟
كيف خُلط بين آداب الحوار ونزع العقلانية من الغضب أو الحماس والشغف؟ وعلى أي أساس استند هؤلاء لتجريم العاطفة الإنسانية ووصمها بالعار وإقصائها من الفضاء العام؟ "يُمكننا في الحياة الاجتماعية أن نسيطر على حالة الحصر النفسي عبر ارتداء القناع: ترتدي القناع وتخفي ما تشعر به.. يدفع ثراء ما يحدث في الشوارع وعابروها سكان المدن للظهور بمظهر خارجي بارد وفاتر، بينما هم في دخيلتهم مهتاجون ومتحفزون. إنها أداةٌ للطبع كُلية الأهمية".
ينسحب المرء اليوم من الحياة العامة نفسياً وذهنياً وينفصل عنها، وهذا انسحاب طوعي يقدم عليه المرء للحدِّ من الحصر النفسي عنده، والمتسبب به النظام الخارجي الذي يقدس الآلة والمال على حساب النزعات الإنسانية الأكثر حقيقة، وفي محاولة المرء الهروب من هذا الاختناق العام، فإنه ينأى بنفسه وينسحب.
ولكن سينيت يشير إلى أن هذه الآلية "تُنتج نوعاً من العماء بدل الاستنارة"، وأنها تستند إلى النرجسية والرضا، أي استغراق المرء في ذاته والإيمان بمن حوله فقط وتحقيق شرفه وجدارته في دائرته الضيقة جداً، منفصلاً عن الآخرين باعتبارهم "غير حقيقيين" أو أقل جدارة منه أو مختلفين عنه اختلافاً يوجب دونيتهم أمامه وفوقيته عليهم.
أما الرضا فتناوله بمعنى بلوغ المرء ذروة الضجر في حياته، يعيد ما يستهلكه جسده وذهنه في آليات مُكررة "يرضى" عنها ولا يتوقع منها المفاجآت، فيأمن فيها وبها بعيداً عن ضغوط العالم الخارجي: "سوف يشعر الشخص المقيم في حالة الاستغراق الذاتي هذه بحالة حصر نفسي حالما يقتحم الواقع حالته، ويشعر بفقدٍ مهدد للذات بدل الشعور بأن التجربة إغناءٌ للنفس.
فيقوم بخفض شدة الحصر عن طريق استعادة مشاعر وضع السيطرة، وبذلك ينخفض الحصر النفسي. عند حصول هذا التحول السيكولوجي الداخلي تنشأ عنه عواقب اجتماعية أكثرها بروزاً التناقض في التعاون الاجتماعي"، ولهذا يُثبت سينيت الضرر الكبير المترتب على هذه الآليات النفسية، في خلق مجتمع لا يؤمن بالتعاون، بل يعده أمراً خيالياً ومثالياً يستحيل تحققه.
لقد تطلب عالم اليوم، الذي يرفض الإنسان ونزعاته وبات يحوله بجدٍّ واجتهادٍ إلى آلة منتجة ومستهلة على الدوام، نوعاً من "اللطافة" التي تقيد نزعات المرء، باسم الآداب والكياسة والأخلاقيات وكل ما يمكن التبرير به، فغدا الإنسان اليوم منزوع الفعل الأخلاقي الذاتي، منزوع الذاتية في الأمر والنهي، لا يثق بنفسه ولا نزعاته، ولا يعدُّ غضبه سوى حالة نفسية مشينة عليه التخلص منها لتحقيق الصورة المثلى عن الإنسان اليوم "المنضبط" و"المتزن": "لإحداث هذا التبدل كان لا بد أن يظهر نمط محدد جديد من الطبع في المقدمة، طبع متهكم من ذاته، أكثر من كونه عدائياً وموارباً، ويفضل الإذعان ويملك طبيعة متحفظة تتشكل حول تقييد الذات".
لقد نجحت الآلة في قلب المفاهيم النفسية في أذهاننا، ونزع ثقتنا في أنفسنا، فمهما كانت بشاعة المشهد أمامنا، والتناقض الذي يصيبه، والمفارقات البشعة التي نشهدها، والجروح الأخلاقية والاجتماعية التي تضني أجسادنا الصورية، ومهما بدى علينا التشوه والانحراف والضعف والذلة، فإننا لا نلتفت إلى هذا كله، ونتمسك باللغة المضبوطة والنفس "المتزنة" والخالية من الانفعال، حتى بتنا نصنف نزعات إنسانية طبيعية على أنها أمراض واختلالات وضعف وسمات يحتاج المرء التخلص منها سريعاً.
ويسرد سينيت عن توكفيل الامتزاج بين النزعة الفردية ومظهر الانسحاب لدى المرء، فيقول:
"كل شخص منسحب إلى داخل نفسه يسلك مسلكاً كما لو أنه غريب عن قدر الآخرين جميعهم. أطفاله وأصدقاؤه الجيدون هم بالنسبة إليه الجنس البشري كله، وبالنسبة لتعاملاته مع نظرائه من المواطنين، فإنه قد يختلط بهم لكنه لا يراهم؛ يلمسهم لكن لا يشعر بهم، فهو موجود في ذاته ولذاته فقط. وإذا ما بقيت في ذهنه تحت هذه الشروط بقايا إحساس بالعائلة، فإن إحساسه بالمجتمع لم يعد موجوداً".
ولهذا، فإن الرضا يتمثل في تقوقع المرء في عالمه، ولا مبالاته بغيره بصورة يمكن أن يُبررها جيداً ومطولاً، ولكنه لن يقع على الخلل الأصل في ذلك، ولن يدرك التشوه الذي أصابه بفعل من يستفيدون من إذعانه.
أما الاستحواذ القهري كآلية نفسية دفاعية أخرى تجاه العالم الذي بات على حافة الهاوية، فإن المرء فيه يُكرر الأفعال والإنجازات التي تضمن له السير على طريقٍ يفضي به إلى "النجاة" أو "النجاح" أو "تحقيق الذات"، عبر آليات لا يمكن أن تفضي به إلى هناك على الإطلاق، خاصة بالكره الشديد للذات الذي يتمتع به هؤلاء وبشعورهم بانعدام الأمان من حولهم، وبالتهديد في كل مكان:
"تبدو له الحياة اليومية تفتقر للمسرة ومليئة بالتهديد. يبدو أن العمل الشاق دون كلل سلاحٌ يقي من مخاطر يفرضها آخرون، فتنسحب إلى داخل ذاتك. تُقلل أخلاقيات العمل من الرغبة في التعاون مع الآخرين، خاصة مع أولئك الذين لا تعرفهم ويبدو أنهم، وقبل أن تتعرف إليهم، يملكون حضوراً عدائياً ميالاً لإلحاق الأذى بك".
قد تتعدد الآليات النفسية الدفاعية تجاه الآلة الخارجية التي تحاول باستمرار تحويل الإنسان إلى كائن مجوف من نزعاته، ولكن هذا الشأن بالذات متسع النطاق والبحث والدلائل، ولهذا فإني أشير إليه من بعيدٍ، وإلى العلاقة التي تربطه بسؤالي:
أين فشلنا بالضبط؟ ومتى نزع منا الحق في الغضب؟ كيف تمت الاستهانة بالتعاون على مرِّ السنين، حتى باتت معاناة بعضٍ منا شأناً لا يخصنا، نتناوله على طاولة الحوار كما نتناول مسائل البورصة والحديث الأدبي وشؤون الاقتصاد والثقافة الأخرى؟
إن نزعنا التهويل عن الأحداث الفظيعة لا يقلل من فظاعتها، بل يجرِّمنا بالتحول عن إنسانيتنا، ومضينا في طريقٍ سنطرح فيه عن أنفسنا الكثير من النزعات الإنسانية، كثمن ندفعه للدخول في آلة تُنتج المال والسلطة فقط، ولا تأبه لأيٍّ منا.
لا تقلص اللغة اللطيفة من بشاعة الحدث، ولا تحدُّ آداب الحوار من مظاهر مهولة تكشف عن وحشية الإنسان الحديث، إن البرود المقرف الذي يسمنا اليوم لا ينزع عن المشهد أيَّ قدرٍ من البشاعة، بل يُنقص منا حقيقتنا، وينزع منا جوهرنا الذي التففنا حوله، ويدعنا كائنات مجوفة جاهزة للتعبئة، وليس هناك ما نعبأ به سوى أيديولوجيات الرؤوس المالية.
إننا نفقد ذواتنا باستمرار، ولكننا مع ذلك، لا زلنا نتمسك "بآداب الحوار"، ولا يمكن أن نفطن إلى ما يجري بنا إلا بلحظة تأمل حقيقية، نقيِّم بها الأمور ونزنها، بما تبقى من حقيقتنا، لعلنا نعود إلى جادة الصواب.
للإنسان حقٌ كامل في الغضب والاعتراض والرفض، وعندما تزداد فظاعة المشهد أمامه ويفقد العالم صوابه، فليس لنا لغة ملطفة ولا حوار هادئ ولا ضبط مصطلحات ولا أية محاولة لتقنين النزعة الإنسانية المعترضة على فشلنا، يجب أن نجابه بشائعنا بالقدر ذاته من السخط اللغوي الذي يتبعه رفض عارم لهذا الفشل، ومحاولات حقيقية للتصحيح السريع، ولكننا مع ذلك، ننظر اليوم إلى "الآلة اللغوية المُلطفة"، ونرجو منها تلطيف المشهد، ولو بأمانٍ لا واعية ندرك عدم جدواها.
ولأن السؤال يجرَّ السؤال، ربما يحق لنا التساؤل بعدئذٍ: ما الذي سيسقط منا في الأعوام المقبلة؟ ما الذي سنتخلص منه من نزعاتنا التي تعرِّفنا بدعاوي التحضر والتأقلم والتفهم والتحاور والتحول إلى التجويف المتعمد؟