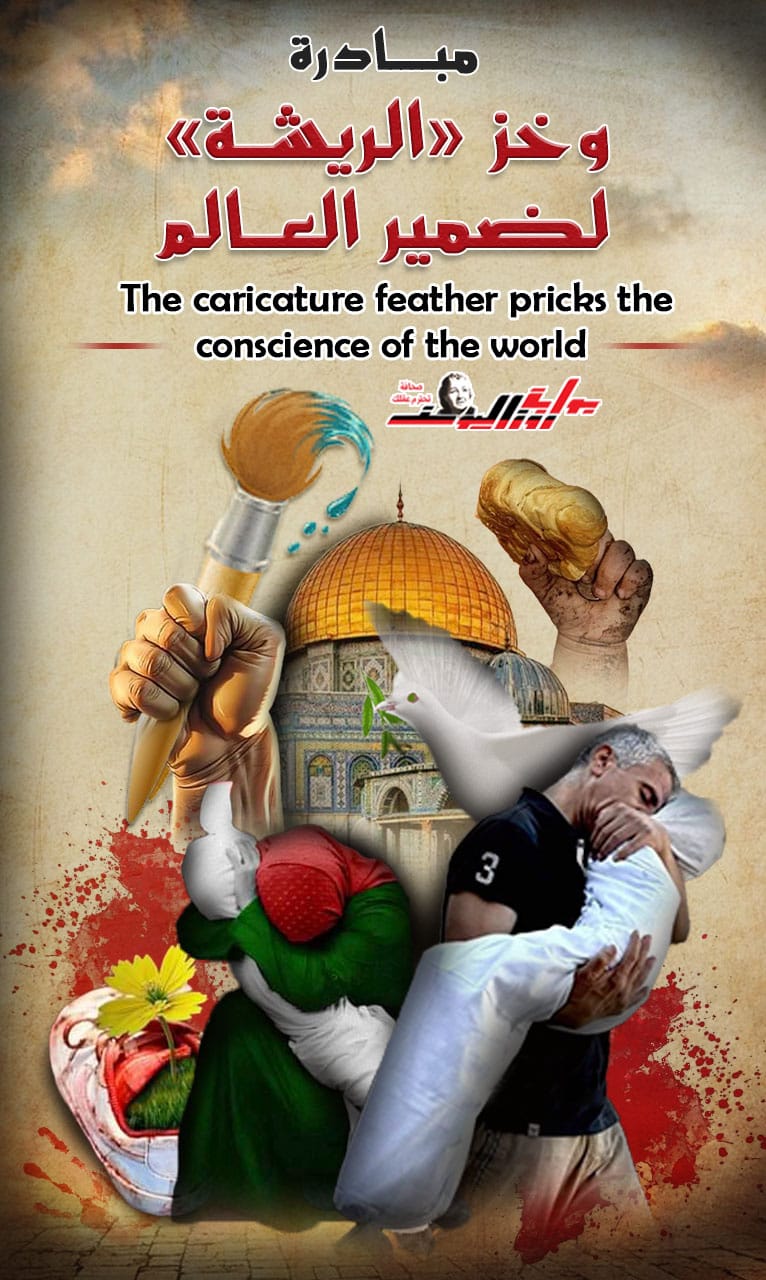لحسن العسبي
في معنى السخرية
بقلم : لحسن العسبي
هل يسير دوما مواجهة الحياة بقلب طفل؟. هذا شرف لا يمنح للجميع. لأنه قليل من بيننا، من يدرك باكرا، أن الإنتصار على العدم، لا يكون بغير أن لا نسقط في جدية "اقتراف الحياة". فالحياة ليست جدية إلى الدرجة التي يتوهم الآدميون، قدر جدية الموت. أكاد أقول جدية الغياب. ألم يقلها هايدغر ذات مساء، أن المرء حين يولد يقدم وعودا كثيرة للحياة، لكن الوعد الوحيد الذي يفي به هو وعد الموت. الذي قد يكون بعد ساعة من الميلاد، وقد يكون بعد مئة عام، لكنه وعد يوفى. ألم يقلها قبله الفيلسوف المشاء، سقراط. أن سقراط ليس الطبيب، بل الموت هو الطبيب، وأن سقراط لم يكن سوى المريض. ربما كان قصده أنه "كان مريضا بالحياة".
بالتالي، فإن الحياة التي تستحق أن تعاش (عكس ما قد يتوهم البعض)، لا تستحق أن تعاش بغير قلب طفل. ذاك الضاحك دوما، المنطلق أبدا، الصادق دائما مع ذاته ومع إغفاءة المساء العميقة، على مخدة أمه: الأرض. حينها فقط، تسلس لك الحياة، وتدرك أنك حين تقترفها، لست سجين أي حساب غير أن تكون مجرد سمكة مناسبة في ماءها الأبدي. إنه هنا، يقين العابر، ذاك الذي يدرك أن ما يتبقى ليس الأثر بالضرورة، ولا وهم الأزل، بل الذي يتبقى هو ما اقتنصته من معنى التصالح مع الطفل الذي فيك. كم منا ينجح حقيقة في ذلك؟
مصطفى المسناوي نجح في ذلك، بالطول وبالعرض. لهذا السبب، هو لا يهتم كثيرا بالذي نقوله عنه الآن، لأنه مارس الحياة بيقين المؤمن أنه ذاهب إلى أمه هناك، الأرض. وكان وهو يقترف الحياة، لا يسجن نفسه سوى في أن يعبر شفيفا بين شعاب الوجود، تلك التي ترسم لها خرائط في أعين الناس وذبذبات التقاطهم ضمن نقط تقاطعات الحياة. التقاطعات التي قد تكون بيت عائلة، أو محطة سفر، مطار أو محطة قطار، أو مقهى ومطعما، وقد يكون قاعة سينما أو مهرجانا هنا وهناك. لهذا السبب نجد الرجل انتصر باكرا للسخرية، في القول وفي الفعل. السخرية في الكتابة القصصية والسخرية في المقالة الصحفية والسخرية في سيناريوهات أعمال فنية عدة، منذ ثنائي بزيز وباز، حتى سيتكومات محمد الجم. وظل دوما لاقطا نابها لمزالق اللغة وفخاخها في طريق التعبير المفتوحة لنا جميعا. ووحده من كان يقرأ في الجمل معاني ثاوية، لا تراها غير عين أخرى لا تتحقق بصيرتها لكل الناس.
هنا تكون المتعة القصوى مع المسناوي، أنه يقلب اللغة من أوجه معانيها المتعددة، مثلما يقلب العاشق معاني الفتنة في روح معشوقته وليس فقط ضمن خرائط مفاتنها البارزة للآخرين. فالرجل كان مدركا، من زمان، أن داء الإنسان (خاصة ذاك المسمى المغربي والعربي والمسلم)، كامن في شكل علاقته بالمعاني، تلك التي تمشي في الطرقات، تصنعه ويصنعها، دون أن يدرك أنه حين ينزل بالفأس على الشجرة إنما ينزل على جدره الأصل. لهذا السبب سلخ عمرا كاملا، كي يساعدنا جميعا، في مكان ما، على أن نعيد تأمل سؤال المعرفة، في مناطقها التأسيسية السرية، تلك التي للتربية والتعليم. فكانت مشاريعه في "الجامعة" (الجريدة والمؤسسة أيضا)، وفي "بيت الحكمة" (المجلة والمعنى)، وأيضا في مجال ثقافة الصورة (خاصة في مفاوزها الحاسمة، تلك التي يصنعها التلفزيون في يومي الناس الطيبين، الطيعين، المتعطشين للتصالح مع معاني وجودهم المغربي).
المسناوي، بفطنة نادرة، لم ينسق دائما وراء الثقافة العالمة، المحنطة في النظرية، بل إنه حاول (ويكفيه هنا شرف المحاولة، التي بقيت أثرا عنه في ذاكرة الكتابة المغربية)، أن يحفر في الأساس الذي يصنع المعاني، ذاك الذي نسميه عادة التربية. وظل دوما مؤمنا، في صمت (وفي مكر أيضا، أي ذلك المكر الذي لا يعلن أبدا عن خططه الثاوية)، أن الأساسي في الفعل، فعل المعرفة، هو في رسم خرائط الوصفة المفسرة لقلق الفرد أمام الحياة. هنا أصبحت الفلسفة مع المسناوي، ليست خطاطة خطابية تنظيرية، بل بناء تأسيسيا. يبصم في الفرد، الذي يصطدم بمشاريعه في الكتابة وفي المقالة وفي السيتكوم، لوثة للإيجابي لا تمحي بسهولة، مثل الوشم الذي يبقى أبديا في ظاهر اليد.
ولأن الرجل كان ينفر من كل مؤسسة، لأنه يضيق بجدران مصالحها وحساباتها الخاصة، فإنه قد انتصر عليها بالتعايش مع صلافتها، بما يحقق له الأهم، أن يمارس حياته بذات الشغف الذي يريد. ذاك الذي يكون للطفل حين يخاتل إكراه نظام التربية الأبوية، عبر منح الأب صورة الإمتثال، لكنه في حديقته السرية (تلك التي تكون تحت سرير الوجود)، يمارس فرحه الطفل باللعب مع الحياة، بدون حاجة للجدية، بل، عبر فن السخرية. لهذا السبب، كان المسناوي دوما ضاحكا، ألوفا، لا تستشعر أبدا الملل في حضرته، وكان حتى مع المرض (لم يؤمن قط أنه مريض، بل ظل دوما مؤمنا أن تمة فقط خللا في الحساب، وأن الموت وحده من سيعيد العداد إلى أصله الصفر)،، حتى مع المرض كان يمنحه أن يكون حالة عابرة مثل أي عطسة أثارها غبار الوجود. ولم يغير أبدا من عاداته، تلك التي تفرضها مؤسسة الطب. والظاهر أنه حتى مع هذه المؤسسة، مارس شغبه الطفل، بذات رؤية ميشال فوكو، ذاك الذي حلل برؤية ناقدة ماكرة "وهم الطب".
كانت للمسناوي هموم أخرى. ففي الطائرة، ذكرني مرة أخرى، بإلحاحية أن نباشر تنفيذ مشروع اقترحه علي منذ سنة، وظل يختمر بيننا، بهدوء، لإصدار مجلة فكرية مغربية، تزعج السؤال المعرفي للمغربي اليوم. كان مؤمنا، حد الهوس، أن اللحظة مواتية للإستفزاز الفكري، لأن المغربي أخيرا وصل بر الحداثة، تلك التي تجعله في مفترق الطرق بين أن يقطع الوادي وبين أن يظل مترددا مخافة أن "تفزك رجليه". هو يقصد، أن المغربي يريد التحول، لكن بدون ثمن.
ها هو كما ترون، قد عاد ليتصالح مع من هو. ذاك المربي الذي يوقن أن مفاصل التحول تكمن في الحفر في وجدان المعرفة، تلك التي تؤطر سلوك الناس، وأن ذلك لا يتم إلا عبر السخرية من جدية النظرية والحياة. فالمسناوي هنا، إنما ظل دوما من أصحاب "فاوست"، ذاك الذي أبدعه "غوتة"، الذي ظل يصيح في العالمين: "إن النظرية سوداء اللون دوما، بينما شجرة الحياة أبدا مخضرة". وظل مؤمنا أيضا، أمام تفصيل المرض، بقلب الطفل الذي كان، بحكمة الشاعر اليوناني يانيس ريتسوس، التي تعلمنا أنه: "إن كان هو الموت دوما، فهو يأتي تاليا. الحرية أبدا هي الأولى". والمسناوي إنما مارس الحرية فقط.
(*) نص الكلمة التي ألقاها لحسن العسبي في "لقاء الوفاء" الخاص بالكاتب المغربي الراحل مصطفى المسناوي، الذي نظمه المكتب المركزي لاتحاد كتاب المغرب بالمركب الثقافي كمال الزبدي بالدارالبيضاء، مساء الجمعة 1 أبريل 2016.