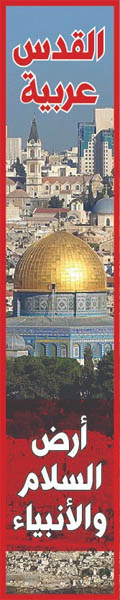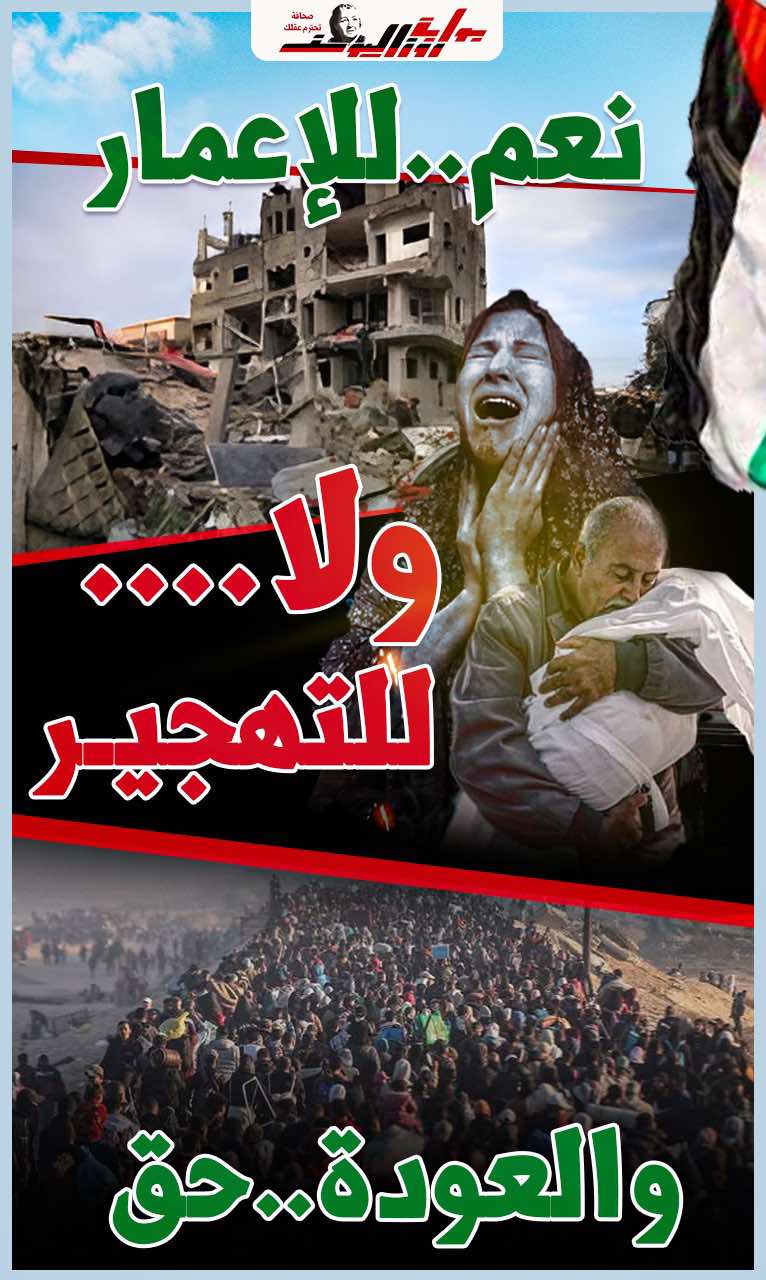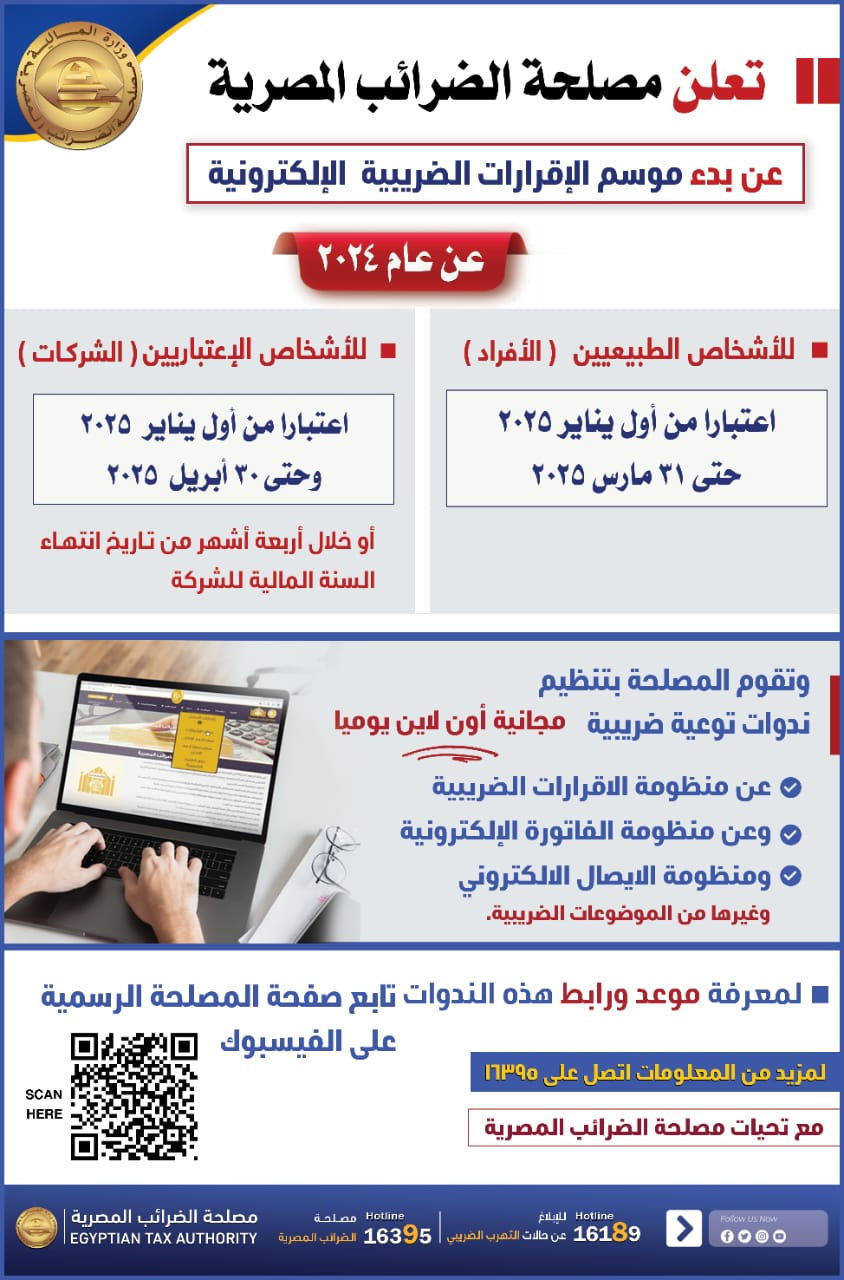أسامة سلامة
المادة المنسية فى الدستور القادم
بقلم : أسامة سلامة
اسامه سلامة
فى عام 1983 أصدر القاضى محمود عبدالحميد غراب حكمين : الأول بقطع يد متهم بالسرقة والثانى بجلد مواطن اتهم بالسكر، واستند فى الأسباب إلى أحكام الشريعة الإسلامية ووفقا للمادة الثانية من الدستور والتى تقول: مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.. وقتها قامت الدنيا ولم تقعد.
وامتدت المناقشات هل من حق القاضى أن يتجاوز القانون، ويستند إلى الدستور مباشرة فى أحكامه، أم أنه ملتزم بالنصوص القانونية وأن من حقه فقط إحالة القانون الذى يرى عدم دستوريته إلى المحكمة الدستورية لتنظر فيه؟
حقيقة، الحكم تم إلغاؤه فى محكمة الجنح المستأنفة، ولكن ظلت القضية مثارة مع كل حكم مماثل خاصة أن الأحكام التى استندت إلى المادة الثانية من الدستور تعددت بأشكال أخرى،ورغم قلتها إلا أن تأثيرها كان كبيرا وكانت ردود الأفعال عليها متباينة حتى كادت أن تصيب المجتمع باضطراب هائل.
مثلا: حكم أصدرته المحكمة المدنية بإلغاء غرامات وفوائد التأخير لمخالفته للشريعة الإسلامية، وكان أحد المقاولين قد أقام دعوى على الأزهر مطالبا بفوائد تأخير مستحقاته نظير أعمال قام بها ولكن محامي مؤسسة الأزهر قال فى دفاعه أن هذه الفوائد ربا واستجابت المحكمة لهذا التفسير المستند إلى المادة الثانية من الدستور، واهتزت الدنيا للحكم، وارتجت البنوك والمؤسسات المالية والتجارية وترقبت المصارف العالمية هذه القضية، ثم جاء حكم الاستئناف لاغيا للحكم الأول استنادا إلى أن القانون المدنى والتجارى صدر قبل دستور 1971وأن عدم الدستورية ينطبق على القوانين التى صدرت بعده.
منذ إنشاء المحكمة الدستورية والأحكام المستندة للدستور محل جدل وخلاف فقهى، قبلها كانت القواعد القانونية مستقرة على أنه يجوز للقاضى أن يتجاهل القانون إذا رأى أنه مخالف للدستور، ولكن منذ عام 1969 عندما أنشئت المحكمة الدستورية، وبعد صدور أول أحكامها عام 1971 تباينت الآراء الأول يرى أن قاعدة حرية القاضى فى الاستناد للدستور ما زالت موجودة وأنها تشبه المبادئ فوق الدستورية، والثانى يقول أن المحكمة الدستورية وحدها لها حق مراقبة دستورية القوانين، وبالتالى ليس من حق القاضى تجاهل القوانين والاستناد إلى الدستور مباشرة فى أحكامه، وإلا كان معتديا على سلطة المحكمة الدستورية مغتصبا لها، خاصة أن تفسيرات القضاة لمواد الدستور قد تختلف من قاض إلى آخر مما قد يحدث بلبلة قانونية.
ورغم أن معظم القضاة أخذوا بالرأى الثانى، فإن بعض القضاة أصروا على أن من حقهم الرجوع إلى الدستور مباشرة إذا وجدوا أن القانون من وجهة نظرهم متعارض مع الشريعة الإسلامية، وشهدت محكمة القضاء الإدارى عدة أحكام استنادا على المادة الثانية من دستور 1791، خاصة فى الأحكام الخاصة بالعائدين للمسيحية، وهؤلاء مواطنون أشهروا إسلامهم ثم عادوا مرة أخرى للمسيحية، وطالبوا مصلحة الأحوال المدنية بإصدار بطاقات هوية لهم تتضمن معتقدهم الحقيقى.. وعندما تعنتت المصلحة فى الاستجابة لطلباتهم، أقاموا دعاوى أمام محكمة القضاء الإدارى التى قضت بأن أحكام الشريعة تمنع الردة ولا يجوز لهؤلاء العودة للمسيحية.. وفجر هذا الحكم قضايا فكرية ودينية كثيرة حول حرية الاعتقاد وهل هناك حد ردة فى الإسلام أم لا.. وهل يجوز إجبار الإنسان على وضع دين فى بطاقته لا يؤمن به .. وما يترتب على ذلك من معاملات بهذه الهوية غير الحقيقية.. مثل أن أولاده القادمين سيحملون نفس المعتقد فى بطاقتهم رغم أنهم ولدوا بمعتقد آخر.. كان الأمر خطيرا.. ولكن المحكمة الإدارية العليا أنقذت الموقف وألغت هذه الأحكام.. وألزمت مصلحة الأحوال المدنية بمنحهم بطاقات تتضمن الديانة التى يعتقدونها.
نفس الأمر تكرر مع معتنقى البهائية والذين أعطتهم المحكمة الإدارية العليا حق وضع شرطة فى خانة الديانة بعد أن قضت محكمة القضاء الإدارى بعدم أحقيتهم فى ذلك لأن البهائية دين وضعى وليس سماويا.
هذه الوقائع تؤكد أننا قد نقع بعد صدور الدستور الجديد فى مآزق مماثلة، خاصة أن بعض المحامين يستخدمون المادة الثانية من دستور 1971 والتى ستستمر فى الدستور الجديد سواء بوضعها القديم أو بتعديلات تزيدها تعقيدا فى إقامة دعاوى قضائية أو للحصول على أحكام لصالح موكليهم، ويساندهم فى ذلك بعض القضاة الذين يرون أن واجبهم يقتضى الحكم بمبادئ الشريعة الإسلامية حسب تفسيراتهم، وأخشى أن يحاول بعض القضاة السير فى ركاب التيارات الإسلامية بفصائلها المتعددة بعد وصول هذه التيارات للحكم بعضهم اقتناعا بمنهجها وأفكارها وبعضهم طمعا فى الحصول على مكاسب رخيصة، ولهذا فإننى أدعو إلى النص صراحة فى الدستور على أن مواد الدستور موجهة للمشرع وليس للقاضى وأنه لا يجوز للأخير أن يحكم بغير القانون.
إننى أخشى تماما من التفسيرات المتعددة للشريعة الإسلامية، أن ينحاز كل قاض من هذه الفئة التى أتحدث عنها لفصيل بعينه، وهنا قد نرى أحكاما متضاربة بسبب التفسيرات المختلفة لمبادئ الشريعة، فمثلا قد يرى قاض أن فوائد البنوك حرام استنادا إلى فتاوى بعض المشايخ، وأحكام أخرى تراها غير ربوية استنادا إلى فتاوى أخرى مثل فتوى شيخ الأزهر الراحل محمد سيد طنطاوى، وقد يرى قاض تطبيق حد الردة، ويرى آخر أنه لا وجود لهذا الحد فى الشريعة والاثنان مرجعهما فتاوى وآراء لفقهاء مسلمين.
كل هذا قد يحدث اضطرابا فى المجتمع، ولهذا فإنه من الأفضل أن نجعل القاضى يحكم بالقانون وأن يحال الأمر للمحكمة الدستورية فيما لا يتعلق بالرقابة على القوانين، هذه المادة المنسية حتى الآن فى المناقشات حول الدستور القادم تغلق باب الجحيم الذى قد يحرق المجتمع كله.∎