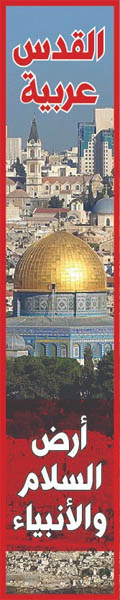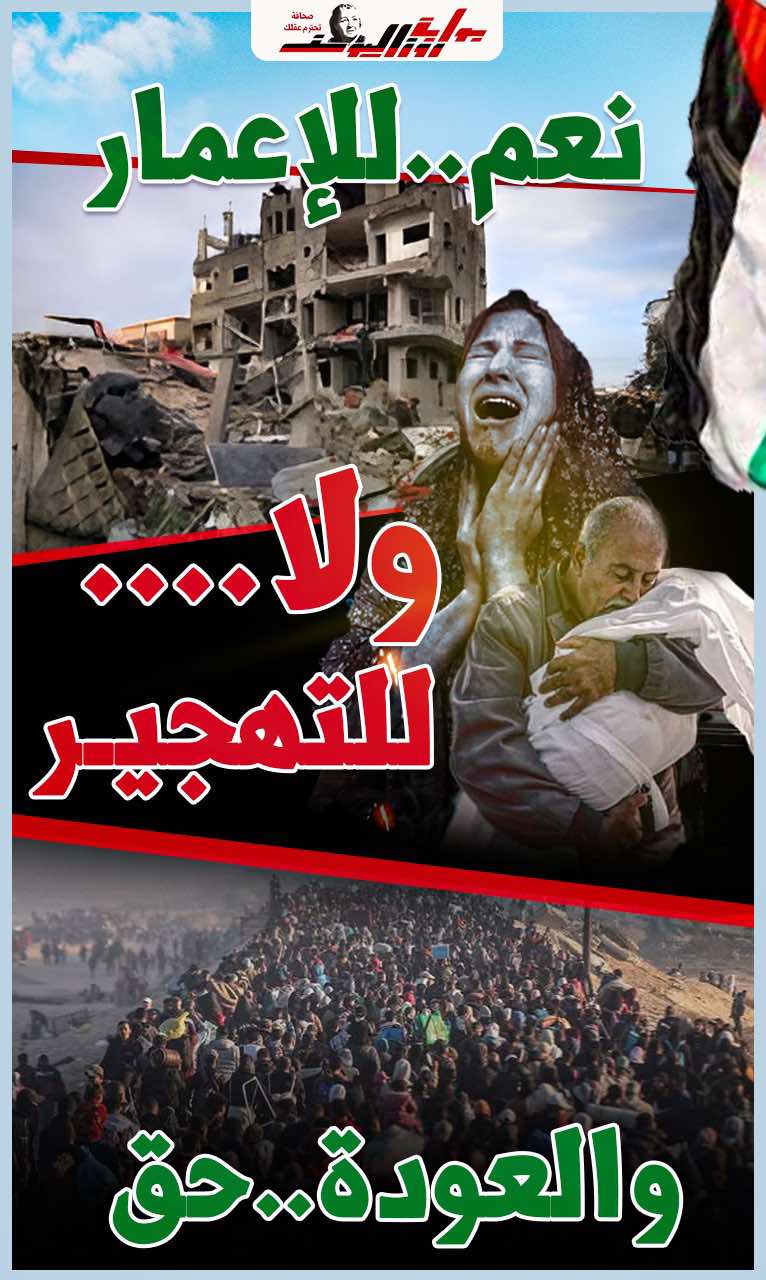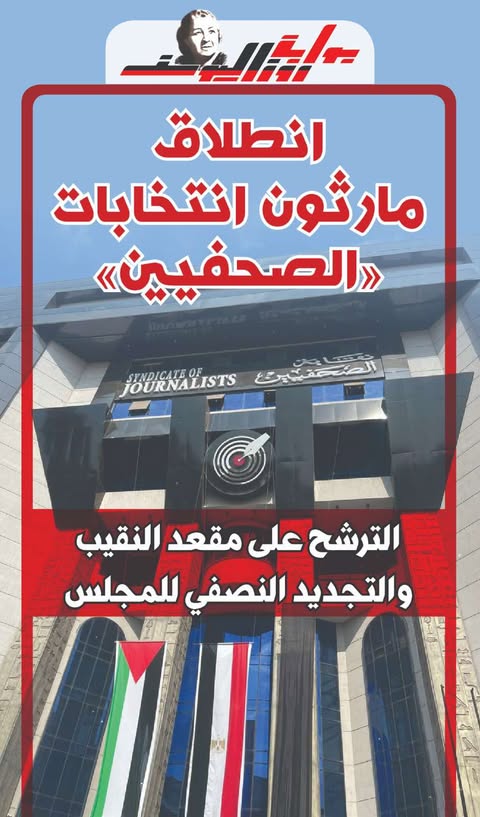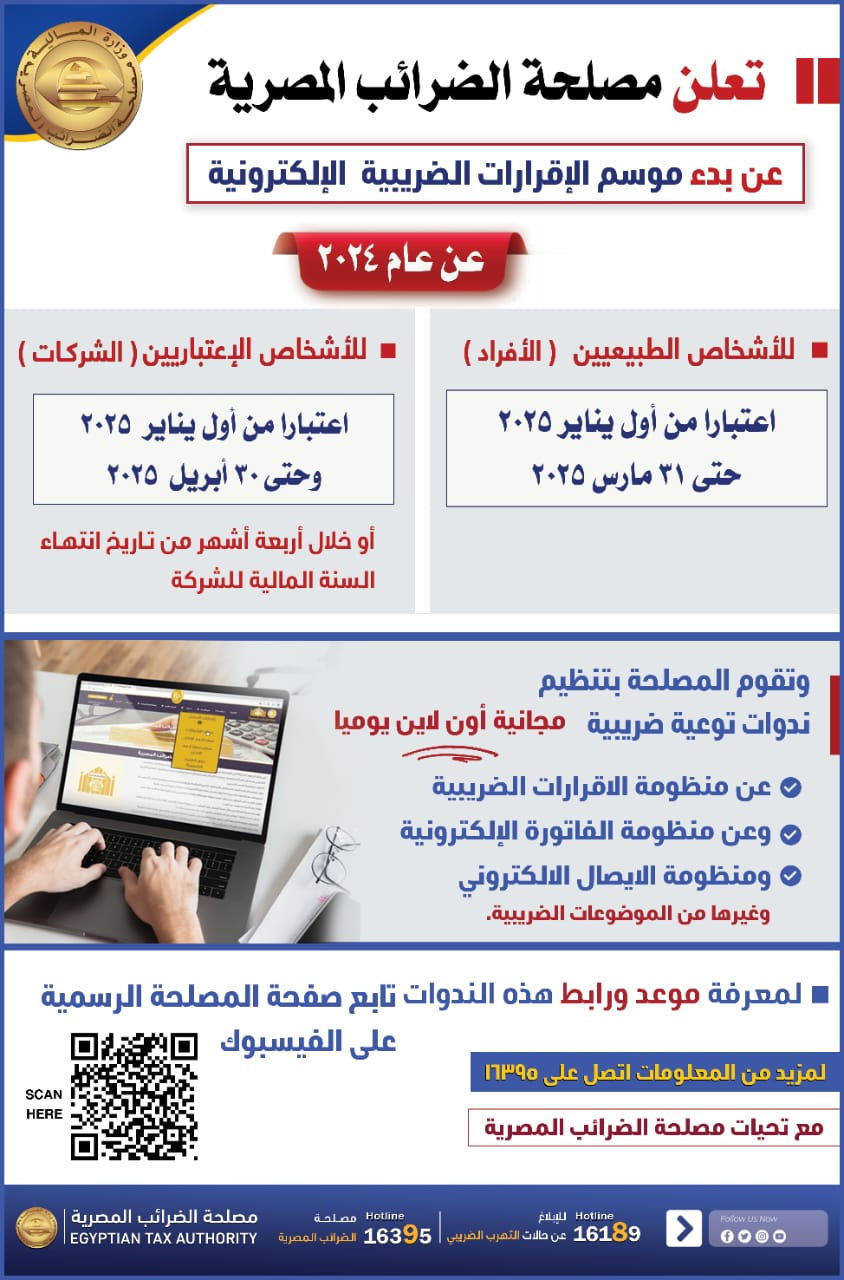د. عصمت نصار
عبدالرحمن بدوي وجوديٌ يعظ
بقلم : د. عصمت نصار
1) بين الفلسفة والأدب
لم يسلك النهضويون التنويريون -سواء في أوروبا أو في الثقافة العربية الحديثة- سبيلاً واحداً لإيقاظ الرأي العام وتنبيه الأذهان وتوعيته بما ينبغي فعله لتقدم المجتمع وانتقاله من طور الجمود والتخلف والتعصب والاستبداد إلى رحاب العلم والتجديد والتحديث والتسامح والحرية. فقاموا بثورات فكرية عن طريق المؤسسات التعليمية والتربوية والتثقيفية وعقدوا عشرات المساجلات حول قضايا (التراث والتجديد والحرية والوعي والإصلاح) وأقاموا مئات الندوات والجماعات الأهلية والصالونات الأدبية وحلقات التوعية والإرشاد في المقاهي ودور الصحف وكتبوا آلاف المقالات -بالعامية والفصحى في صحف الرأي- لمخاطبة الجمهور والطبقة الوسطى ، وتنوعت مصنفاتهم:- فحققوا النفيس من الموروث وترجموا الطريف من الوافد الأجنبي وألفوا الكتب ونظموا القصائد وابتدعوا القصص والحكايات والمسرحيات والروايات وجعلوا منها أوعية لبسط الأفكار وعرض القضايا وانتخاب الحلول للمشكلات التي يعاني منها الواقع المعيش عقدية كانت أو سياسية أو أدبية أو فنية أو لغوية أو اجتماعية وقد تباينت رؤى التنويريين تبعا للمشروعات التي قدموها تجاه المشكلات والقضايا المطروحة فظهر منبر المحافظين الرجعيين ومنبر العلمانيين المستغربين وبينهما منبر الوسط الذي كان يمثله أئمة المحافظين المستنيرين وانبثقت من هذه المنابر العديد من المدارس الفكرية التي كان يجمع أعضاءها مبدئي الصحبة والاقتناع. ويعد عبدالرحمن بدوي من أوساط المثقفين المصريين الليبراليين الذين ينتمون إلى مدرسة محمد عبده ثم مدرسة مصطفى عبدالرازق الفلسفية ، وهي المدرسة الأم التي تخرج فيها معظم أساتذة الفلسفة في العالم العربي والإسلامي –بالتتلمذ المباشر في الجامعة أو غير المباشر خلال المؤلفات واعتناق الأفكار والترويج لها-.
والمشهور عن عبدالرحمن بدوي أنه رائد الفكر الوجودي في الثقافة العربية ويعتبر من كبار المفكرين الموسوعيين إذ بلغت مصنفاته نحو 150 عملا في ميدان التحقيق والترجمة والتأليف. ولم تكن إجادته للعديد من اللغات الأجنبية وراء هذا الزخم المعرفي فحسب بل كانت قدراته الفائقة على التأليف بين الأفكار والجمع بين الحقول المعرفية المختلفة في سياق واحد ، الأمر الذي أثمر ذلك المصنف النادر الذي سوف نتحدث عنه في السطور التالية:- ألا وهو كتاب (هموم الشباب) ، وهو مؤلف أدبي أو إن شئت قل فلسفي أدبي (وقد نشر عام 1946 عن مكتبة النهضة المصرية ) جمع فيه المؤلف آراءه وأفكاره ونزعاته وسكبها في قالب أقرب للرواية منه إلى القصة القصيرة ، وهذا الدرب من التأليف قد انتحله من قبله التنويريون الأوربيون مثل "فولتير" في قصته (كانديد) ومسرحية (سقراط) ذلك فضلا عن معظم الوجوديين المعاصرين. أما في الثقافة العربية الحديثة فقد انتهجه "أحمد فارس الشدياق" في كتابه (الساق على الساق) ، و"علي مبارك" في كتابه (علم الدين) ، و"أبونضارة يعقوب صنوع" في أقاصيصه وحكاياته ، و"عبدالله النديم" في التنكيت والتبكيت ، و"محمد المويلحي" في حديث عيسى بن هشام ، و"مصطفى عبدالرازق" في مذكراته (مذكرات الشيخ حسن الفزاري). وتقع الرواية في 182 صفحة ناقش فيها المؤلف العديد من القضايا التي تهم الشباب منها (تقليد الأجانب – الانحراف الجنسي – حرية الاختلاط والعفة – الذوق الفني وموسيقى الجاز – أكذوبة الغرب المعلم والمتسامح والداعي للحرية والإخاء والمساواة – قضية الوافد والموروث والمجون والاعتدال – واليأس والانتحار) وذلك كله في سياج روائي دارت أحداثه بين إحدى بنات الهوى ورفيقاتها من الساقطات وأحد أصدقاءه -الذي لم يصرح باسمه- ورفقاءه من الشباب المؤمن بالحرية (كاتب - فنان – طيار – عالم). وحدد زمان الرواية بالفترة الممتدة من أخريات الثلاثينيات إلى نهاية الحرب العالمية الثانية. أما المكان فعينه في الملاهي التي تجمع بين المراقص والبارات ، ثم استحضر خلال السرد الروائي الريف المصري وشارع الأهرام وسفح المقطم وأخيرا السجن وذلك في مساحات محدودة من أحداث الرواية. والجدير بالإشارة أن المؤلف حرص على تصدير الرواية بتحذير ينهى فيه القراء عن أي محاولة للربط بين شخصية المؤلف وبطل الرواية جاء فيه: "كل محاولة للربط بين بطل هذا الكتاب وبين مؤلفه مصيرها الإخفاق الشنيع فما هو إلا عرض لمأساة صديقٍ أفضى إليَّ في لحظاته الأخيرة بمكنونها ، وما كان لي بها ولا بالأشخاص الآخرين معرفة من قبل على الرغم من وثاقة ما كان يربط بينه وبيني من صلة روحية عميقة. وما أنا بمسئول عن شيء فيه دق أو جل ، فليطمئن للجميع بالهم من هذه الناحية ، وكل مسئوليتي في أني آثرت جانب النشر على جانب الطي ، وهو قد ترك لي الأمر أختار أحدهما. فإن وجد فيه الشباب القلق من أبناء هذا الجيل صورة صادقة لشيء ما يجول في نفوسهم حينما ينطوون عليها ، وكان في هذا بلسم لقلوبهم المكلومة بجراح الشك والحيرة والتوثب نحو المجد ونشدان البطولة في أروع معانيها ، فبها ونعمت. وإن رأوه من القتامة والغموض والإسراف في القلق والقسوة في تشريح الحياة بحيث لا يتصل بنفوسهم القانعة الراضية السمينة فهنيئا لهم هذه البراءة والصفاء ولست ألتمس منهم أن يعكروهما بقراءة مثل هذا الكتاب ، وكل ما أسألهم إياه أن يضعوا إكليلا من الزهر الأزرق على قبر بطله الشهيد إن مروا به عابرين".
وأعتقد أن هذا التحذير يحمل العديد من الدلالات أولها تقية المؤلف وخوفه من سخط الجمهور وغضبة من يحيطون به ، ويؤكد ظني هذا إخفاءه أسماء كل أبطاله ووصف قلمه بأنه مجرد راوي لما قُص عليه بيد أن المسحة الفلسفية والإحالات المعرفية التي وردت على ألسنة المتحاورين وإسقاطاته على الأماكن وتحليلاته للأحدث كل ذلك ينبأ بأنه البطل الحقيقي لهذه الرواية.
وعلى أي حال فإن التحذير لم ينبأ عن ذلك فحسب بل أفصح عن رغبة المؤلف في توجيه الخطاب إلى الشباب المصري بمنأى عن لغة الوعظ التقليدية ، وذلك لأنها تتعارض مع نزعته الوجودية التي ترفض التوجيه أو الإرشاد من الآخر الذي يشكل عنده أحد القيود التي تعيق اكتمال هويته وتسلبه القدرة على التدبر والاختيار بغض النظر عن القيم التي وضعها المجتمع لتلك الاختيارات.
وصفوة القول أن المؤلف لم يرد بخطابه هذا أن يشكل ثورة على المألوف بل بسط رؤيته في هدوء بمعزل عن ميدان النزال وحلقات السجال ، ويبدو ذلك في دعوته القراء غير القانعين بما في الكتاب بالترحم على صاحب الحكاية فحسب.
ولا يفوتنا ذكر نص الإهداء الذي خطه المؤلف لقرائه وذلك لأنه يكشف عن تلك النزعة الوجودية والأسلوب الرمزي والقدرة الفائقة على استخدام أسلوب التناص والتوجيه الإيحالي والإشاري ونصوص كامنة وراء الستائر السردية فها هو يقول: "إلى الأفعى الرهيبة التي أوردتني موارد الخطيئة في جحيم الشهوات فاقتحمت عليّ برجي العالي ، أنا الأعزل ، واختطفتني ثم قذفت بي من حالق التيار المتدفق لنهر الحياة ، وما كنت أعلم السباحة فهويت في القاع مرات كانت تنتشلني فيها بشصها الذهبي الزائف فلا ألبث حتى أغوص من جديد في أسوأ قرار إلى أن أُسدل الستار على ختام تلك المأساة. إليها أهدي هذه الصفحات التي سطرتها بيمينها ، سائلا الله لها الغفران ولي الرضوان. (شهيد الشباب)"
ويمكننا تتبع تلك الرموز (الأفعى – البرج العالي – نهر الحياة – الستار – الغفران والرضوان – شهيد) فهي بدون أدنى شك يمكن صياغتها بصيغ كثيرة وتوليد منها عشرات الصور وذلك إذا ما انتحلنا التفكيك في القراءة.
أما مضمون الرواية فيناقش كما أشرنا أشهر قضايا الشباب الريفي المصري في هذه الحقبة ألا وهي قضية الاختلاط بين الجنسين في المدينة حيث الإباحية والمجون وأماكن اللهو وعشرات الساقطات الغانيات والمعروفات ببنات الهوى وما يحدث في المراقص من فجور وعناق وموسيقى صاخبة تخاطب الجسد أكثر من مداعبتها للذوق والمشاعر ، علما بأن بيوت الدعارة والممارسات الجنسية كانت مباحة في مصر منذ القرن السابع الميلادي وذلك في ظل حكم الرومان والفرس ثم في عهد العثمانيين وقد ازدهر البغاء مع تزايد الأجانب في مصر بداية من الحملة الفرنسية والتوسع في جلب العمالة الأجنبية في عصر محمد علي الذي شرع في تنظيمها عام 1837م ، غير أن تقنين تلك المهنة لم يحدث قبل عام 1885م (الترخيص) حتى قانون إلغاء البغاء عام 1949م.
ويعني ذلك أن المؤلف كان محقا في وضع قضية الممارسات الجنسية على رأس الموضوعات الخاصة بهموم الشباب ، وأعتقد أنه كان مصيبا في ذلك فتكشف الإحصائيات المعاصرة أن الشباب المصري من أكثر شباب العالم إطلاعا على المواقع الإباحية ويحتل المرتبة الرابعة بعد أمريكا وإيران والإمارات ، فما زالت قضية الجنس والدعارة المباشرة وغير المباشرة والممارسات الشاذة تشغل الحيز الأكبر في تفكير الشباب في الريف والمدن على حد سواء ، والأغرب من ذلك أن العديد من المؤسسات الإعلامية الغربية غزت الأسواق منذ سبع سنوات بمئات أفلام الكرتون التي تصور باستفاضة كل الممارسات الجنسية ، والكارثة أن الكثير منها باللغة العربية وتعرض للأطفال مع موضوعات أخرى ليست أقل خطورة منها على مشاعرهم وأذهانهم دون أدنى رقابة.