
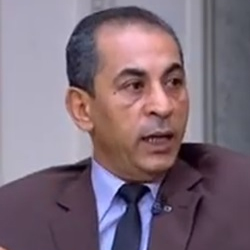
د. حسام عطا
مصطلح الدراماتورج.. محاولة حل الالتباسات
الفارق الجوهري بين الرؤية النقدية والرؤية الإخراجية
الدراماتورج.. إنه ذلك المصطلح الذي انتشر انتشارا كبيرا في المسرح المصري والعربي خلال العقد الأخير، وهو مصطلح لقي مقاومة عندما تم طرحه من المختصين الدراميين في أواخر القرن العشرين المنصرم في مصر.
ولذلك حرصت في الندوة التثقيفية التي أقامها المهرجان القومي للمسرح في أسيوط في الخامس والعشرين من يونيو الماضي 2025، أن أناقش هذا المصطلح محاولاً تبديد الإلتباسات المتعددة حوله.
فكانت تلك الندوة بعنوان الفارق الجوهري بين التحليل النقدي والتحليل الدرامي للرؤية الإخراجية للنص المسرحي.
ولذلك كان علينا أن نناقش مع مجموعة المسرحيين المبدعين هناك عدة أسئلة:
أولاً: ما التحليل النقدي؟
ثانياً: ما شرط الموضوعية والحياد في تحليل النصوص نقدياً عبر فهم تاريخ كتابتها؟، وما المرجعيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية؟
ثالثاً: ما الخبرات الجمالية المتاحة للجمهور وللمؤلف ؟، وما المدرسة الإبداعية والتيارات البارزة في فن الكتابة، والتي صاحبت فترة كتابة النص؟
رابعاً: ما الفارق الجوهري بين التأليف المسرحي والإعداد المسرحي، والدراماتورج، وعملية تهيئة النص لظروف فريق العمل، والظروف العامة المصاحبة لتوقيت ومكان إنتاج العرض المسرحي؟
خامساً: ما شروط عملية تحليل النص المسرحي تحليلاً منحازا لتحقيق الرؤية الإخراجية، وما هي شروط اختلافها الجوهرية عن عملية التحليل النقدي للنص؟
سادساً: ما نموذج التلقي الافتراضي، الذي يجب أن يتصوره المخرج لتحقيق الأهداف الجمالية والفكرية المناسبة لنوعية الجمهور المستهدف ومكان وتوقيت العرض المسرحي، والإطار المرجعي العام له على كل الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، بل والأحداث الإقليمية والدولية؟
سابعاً: ما مسألة تعدد مستويات التلقي ؟
أ) المتلقي الخبير صاحب التراكم المعرفي والجمالي في مشاهدة المسرح ومنهم النقاد - الصحفيين – أهل المهنة المسرحية والمختصين.
ب) الجمهور المهتم صاحب الخلفية الثقافية العامة والذي راكم خبرة في عودة الذهاب إلى المسرح.
ج) الجمهور العام.
د) الجمهور الذي يتعرض لتجربة مشاهدة المسرح للمرة الأولى.
ثامناً: ما علاقة المسرح المتاحة والمستقبلية مع الكاميرا في عصر التكنولوجيا الأثيرية، والتي توفر القدرة على التحرر من دائرة المكان المحدود إلى رحابة البث للعالم كله؟
وفي ذلك دارت مناقشات ثرية وعميقة رأيت أن أستعيد بعضا من أصدائها، فمثلا تداولت الأراء استقرارا على أن عملية التحليل النقدي تحتاج لحياد تام من الناقد، لا يظهر فيها تفسيره الخاص أو قرأته الإبداعية للنصوص، ذلك أن مسألة التحليل النقدي شرطها الجوهري الموضوعية الكاملة.
ويأتي شرط الموضوعية أن يعود الناقد في فهم تلك النصوص إلى تاريخ كتابتها والإطار المرجعي المصاحب لذلك التاريخ.
على أن يضع في اعتباره مسألة الخبرات الجمالية المتاحة للجمهور وللمؤلف وأهم المدارس الإبداعية وأساليب الكتابة والتيارات المتعددة والتي كانت حاضرة في فترة كتابة النص.
وإذ يعرف الناقد الكبير الفرنسي باتريس بافيز الدراماتورج بأنه:
"عملية ترسيخ النظريات المسرحية والقواعد النظرية بطريقة منهجية".
فإن ذلك التعريف لمصطلح الدراماتورج أراه تعريفا قادرا على حل تلك التداخلات والاستخدامات الكثيرة المتعددة لهذا المصطلح، فهو في أصله اليوناني القديم أسمه "dramatourgos"، أما صيغته المعاصرة فهي Dramaturgy باللغة الإنجليزية.
وهي في اللغة الألمانية تأتي Dramaturg، وهي الكلمة الأكثر انتشاراً في الاستخدام العربي والمصري بل وحول العالم.
ويرجع ذلك لأن أول من أطلق هذا المصطلح في العصر الحديث هو الألماني ليسنج (1729 - 1781)، حيث كان هو المؤلف الحديث الذي أهتم كثيرا عند كتابة النصوص المسرحية بالعودة للإطار المرجعي للجمهور، وقد كان ليسنج تاريخياً هو أول من أعاد اطلاق المصطلح بمعناه الذي تطور تدريجيا عبر القرن التاسع عشر ثم أحتل مكانة بارزة في القرن العشرين، ثم أصبح يحمل صيغة ما بعد حداثية مع بداية القرن الحادي والعشرين.
ثم جاء الكاتب الكبير برتولد برخت الألماني الذي ابتكر النظرية الملحمية في الكتابة والإخراج حتى صار هو أرسطو العصر الحديث في نظرية المسرح، والتي خالف بها أرسطو تماما في وظيفة المسرح وأدواته الجمالية.
ويعتبر برخت هو النموذج الأهم والذي يصعب تكراره في مسألة الجمع بين التأليف والإخراج معاً.
فقد تولى برتولد برخت مسؤولية الدراماتورج في مسرحه على صعيد الجانب التقني والعملي في النصوص المسرحية، بينما ترك الناحية الفكرية والفلسفية لبرتولد برخت المخرج المبدع صاحب الثورة الكبرى في عالم المسرح المعاصر.
إذ يبقى برتولد برخت (1898 - 1965) علامة فارقة ونادرة للجمع بين المعارف النقدية والإبداعية في تأليف الدراما المسرحية وإخراجها إخراجاً جمالية وفقاً لفكرة إيقاظ عقل ووعي المتفرج.
وفي هذا الإطار فقد انتصر مصطلح الدراماتورج في أوربا الشرقية، حتى صار وظيفة رسمية مع حلول النصف الثاني من القرن العشرين، كما أنه ظهر في مصر بوضوح في دور المكاتب الفنية للفرق المسرحية المصرية، والتي ضمت في عضويتها كبار النقاد والكتاب مثل: د. محمد مندور ود. رشاد رشدي ود. علي الراعي، وغيرهم من كبار العقول المسرحية وصناع الثقافة والإبداع.
وفي تلك المرحلة المصرية في ستينيات القرن العشرين ومع حضور تلك المكاتب الفنية وتأثيرها الاستشاري الفاعل، استقرت المصطلحات دون التباس أو خلط، على النحو التالي:
أ) الإعداد الدرامي وهو المعالجة الدرامية عن الرواية أو القصة أو الأسطورة أو أى جنس أدبي آخر بما فيه الحكايات الشعبية إلى النص الدرامي، أى الأعداد من فعل السرد إلى فعل يحدث الآن، وكان الإعداد الدرامي أو المعالجة الدرامية يحملان نفس المعنى الإصطلاحي، ويدلان على ذات العملية الفنية نفسها، فمرة كانت تعرف تلك العملية بالمعالجة الدرامية، ومرة أخرى كانت تسمى الإعداد الدرامي، ولعل الإعداد أو المعالجة الدرامية لرواية عبد الرحمن الشرقاوي الأرض والتي قامت بها الكاتبة أمينة الصاوي تعد أبرز تلك النماذج التطبيقية على هذا الاصطلاح المسرحي، والذي لا يمكن فهمه على أنه هو الدراماتورج بأى حال من الأحوال.
ب) كما يمكن أن توافق تلك المكاتب الفنية على عملية الإعداد للنص المسرحي لمؤلف راحل من تاريخ المسرح القريب او البعيد، نظرا لعدم وجود المؤلف بشخصه حيا ولذلك تنتفي قدرته على إعداد النص لظروف إنتاجه الجديدة، وفي هذا تمت مسألة الإعداد الدرامي عبر الحذف من النصوص الكبرى الشهيرة دون الإضافة لها عبر الحوار، إذا قام ذلك المعد المثقف في فترة الستينات بكتابة ما يود إضافته للنص في مسألة إعداده للعرض للمخرج عبر استخدام عناصر العرض المسرحي مثل الإشارة، الضوء، الحركة، الملابس، وما إلى ذلك من عناصر العرض المسرحي، وكان وفقا للقواعد المتعارف عليها والمستقرة في مسألة الملكية الفكرية لا يجوز أن يتم إضافة حوار من المعد في حالة إعداد النص المسرحي لفرقة ما لتقديمه في عرض مسرحى ما في مكان ما، وفي توقيت ما.
أما مسألة إمكانية أن يقوم المعد أو المعالج الدرامي بكتابة الحوار عند النقل من جنس أدبي أخر إلى عالم المسرح فذها أمر متفق على جوازه وقبولا وفقا لقانون الملكية الفكرية وللتقاليد الإبداعية في عالم كتابة الفنون الدرامية في عالمنا الحديث والمعاصر.
أما مسألة نموذج التلقي الإفتراضي فهو يعتمد على دراسة جيدة للجمهور المتلقي كي يمكن اختيار العناصر الفكرية والدلالات الفنية داخل العرض المسرحي، وهذه مسألة تختلف من بلد لأخر ومن جمهور لاخر، بل ومن منطقة إقليمة لمنطقة أخرى في ذات العصر وذات التوقيت.
فالمتلقي الخبير يجب أن نرسل له دلالات عميقة في مستوى التلقي أما الجمهور صاحب الخلفية الثقافية العامة والذي إعتاد فكرة الذهاب إلى المسرح فيمكننا أن نخاطبه بمستوى أخرى في التلقي، أما الجمهور العام فلهو أيضا الدلالات التي يجب مراعاة صياغتها بطريقة يستطيع أن يتقبلها ويفهمها ويتمتع بها، أما الجمهور الذي يتعرض لتجرية مشاهدة المسرح للمرة الأولى فلابد أن نرسل له دلالات خاصة وأن نرسي عنده فعل المشاهدة المسرحية، وأن نكون في منتهي التركيز في الجمع بين وحدة الأسلوب الفني ووضوح الرؤية الفكرية، فهو في مرحلة تأسيس التقاليد المسرحية وفهم عملية التلقي، وهي عملية ذات طابع تراكمي.
أما المسرح في عصر التكنولوجيا الاثيرية وعلاقته بالكاميرا فهو إتاحة كبرى تستطيع أن تخرج الإبداع المسرحي من حيز المكان الضيق ليدور في ذات اللحظة كبث مباشر حول العالم عبر الشاشات الرقمية والفضائية اللانهائية.
























