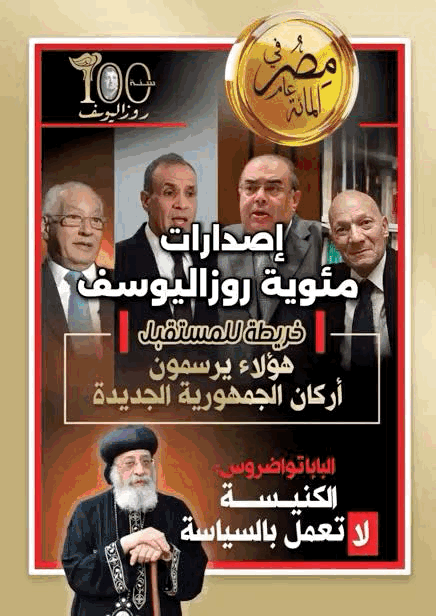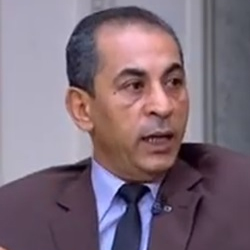
د. حسام عطا
كليوباترا السوداء .. قراءة في الهوية المصرية
يبقى السؤال المطروح الآن على امتداد تأثير تداعيات سلسلة متصلة من محاولات خلخلة الحقائق المستمرة حول الحضارة المصرية القديمة؛ مطروحًا بطريقة واضحة.
إنه السؤال الأهم الذي ظل مطروحًا على المصريين كسؤال ثقافي بالأساس، وبشكل دائم منذ تكوين مصر الحديثة على يد محمد علي 1805 حتى 1848.
وقد حمل مشروع محمد علي التحديثي داخله بذور ذلك التناقض الذي تطور فيما بعد في مصر، وهو التناقض الجوهري بين فكرة الحاكم الفرد القوي ممثلًا في محمد علي الذي حرص على أن يمهد النفوذ القوي لأسرته لتحكم حتى الملك فاروق الأول ملك مصر والسودان 1952.
وبين طبيعة المشروع التحديثي ومشروع الحداثة بشكل عام.
وهو ما ظهر بشكل فكري واضح في عهد الخديو إسماعيل الذي حرص على أن يعلنها واضحة أنه يهدف لأن تكون القاهرة قطعة من أوروبا.
أما جوهر هذا التناقض فيظل قائمًا في الوعي الشعبي المصري، وفي وعي النخبة المتعلمة التي ساهم في صنعها وتعليمها وتمكينها في مصر محمد علي باشا، كي تخدم مشروعه لمصر الحديثة.
وظل هذا التناقض قائمًا في طرح سؤال الهوية، فمن نحن أهل مصر؟ سؤال ظل يزداد حدة وأرقا مع الاحتلال البريطاني لمصر 1882: 1952، وخلال فترة الاحتلال كان سؤال الهوية تم إدماجه في سؤال الوطنية المصرية والحرية والاستقلال.
خاصة أن الارتباط المصري بالحداثة الغربية، وبالتحديد بالحداثة الأوروبية كان ارتباطًا وثيقًا على ما أثاره أيضًا من أسئلة عديدة حول مفهوم الهوية المصرية.
خاصة أن الحداثة المصرية في عهد محمد علي قد ارتبطت بقدر كبير بمفهوم الحداثة الغربية الذي يرى أن العقل هو محور تلك الحداثة، ما يعيد فصل النظرة للدين ولأفكار ما وراء الطبيعة وللأفكار المثالية عن السياسة وعناصر القوة الصلبة.
وهو الطريق الصحيح المنتظر في مصر لإحداث تلك العلاقة المنسجمة التي ننتظرها في أتم حالاتها مع الفقه الإسلامي والتفسير اللاهوتي المنفتح على إعمال العقل والإيمان بأفكار الحداثة المؤمنة وهي أفكار تاريخية ومتجددة معًا.
هذا وسار مشروع التحديث المصري على يد محمد علي، وتعديلات مساره الوطنية المتعددة مسارًا وعرًا بحسب سؤال الهوية المصرية، والذي كثيرًا، ما كانت الإجابات عنه تعطل عمل المسار التحديثي، وأخطر مساراته التي كانت ما تتعطل كثيرًا، هي مسارات العلم والأخلاق والفن.
لأن هذا المسار التحديثي كثيرًا ما رسمت طرق عمله مصالح اقتصادية وفئات اجتماعية وظروف سياسية ونزعات المجد الشخصي الوطني.
وهي العملية المعقدة التي حكمتها إرادة الاستقلال الوطني والصراعات التي حملت اسم الدين واعتقادات النخب التقليدية، وفي القلب منها النخب الحاكمة.
وهكذا بقي مسار الحداثة مهددًا يسير ببطء، ويتعطل في بعض الأحيان بسبب مقاومة التقاليد والمصالح الخاصة له.
وفي ظل تلك التوترات الحادة، حدثت خاصة لدى الطبقة المتوسطة المصرية إجابات خاطئة عديدة عن سؤال الهوية وعلاقتها بالحداثة.
وهو ما ظهر في نقاشات فكرية طويلة حملت عناوين عديدة، ما هي إلا تنويعات على فكرة الأصالة والمعاصرة.
وهكذا ظلت تلك الثنائيات تتوالد في إطار محاولة الإجابة عن سؤال الهوية المصرية.
وفي هذا المسار الطويل ظلت الحضارة المصرية القديمة مصدرًا مهمًا للفخر القومي المصري ومصدرًا للجذب السياحي ولاهتمام القادمين من كل أنحاء العالم لرؤية الآثار المصرية القديمة، إلا أن سؤال الهوية وصلته بالحضارة المصرية القديمة ظلت إجاباته الفعلية على أرض الواقع معطلة ومهددة أحيانًا، ويتم إدماجها كثيرًا في إجابات صادمة عند تمريرها على أسئلة الهوية الدينية.
وكوننا من المعاصرين المصريين هذا أمر جعلنا نرى بأنفسنا بعض من كبار الكتاب المصريين، وهم يحاولون تأكيد انقطاع الصلة بين المصريين المعاصرين والمصريين القدماء، ومنهم الكاتب الكبير أنيس منصور رحمه الله رحمة واسعة، وربما تسلل هذا الاعتقاد إلى عدد من أفراد النخبة المصرية.
ويبقى الأمر الحادث المؤكد أن محاولة نشر هذا الاعتقاد بالصلة المنقطعة بيننا وبين المصريين القدماء ظلت على قدم وساق.
مرة بفعل الأصولية الدينية، والتيارات الوهابية المدعومة بقوة تأثير المال، وبعض منها روج لكونها حضارة وثنية، وهو أمر غير صحيح، فقد عرفت مصر القديمة التوحيد وعرفت البعث ويوم الحساب والثواب والعقاب في الحياة الأخرى.
ومرة أخرى بفعل الإجابات المتعصبة على سؤال الهوية من وجهة نظر العروبية القومية المتشددة. ولذلك ورغم أن حركة المركزية الإفريقية Afrocentrism بدأت بالظهور منذ عشرينيات القرن العشرين الذي غادرنا منذ أعوام، بمعنى أنها حركة لها قرن من الزمان تقريبًا، إلا أن معرفة الرأي العام بها وبخطورة طرحها حول الحضارة المصرية القديمة لم يحدث إلا مع إعلان شركة نتفليكس الأخير الترويجي عن الملكة كليوباترا، الذي أظهرها في بشرة سوداء.
وربما يتزامن هذا الطرح الغريب مع اهتمام مصري ملحوظ بالحضارة المصرية القديمة، بدأ يشغل اهتمام الداخل المصري، مع الاهتمام الرسمي الملحوظ بالمتحف المصري الكبير وما صاحبه من متابعات إعلامية مكثفة.
ولذلك فما يمكن أن يكون ملهمًا الآن هو استعادة سؤال الهوية المصرية في اتجاه مصر القديمة. وهذه الاستعادة يجب أن تتمثل في تنفيذ مشروع د. ثروت عكاشة المؤجل من دون سبب، وهو إنشاء الفرقة المسرحية المصرية المختصة بتقديم الأثر الرائع المصري المسرحي القديم وهو أثر حاضر ومتنوع.
والاهتمام بمشروع إحياء الموسيقى المصرية القديمة، والرقص المصري القديم، ومنح الآثار المصرية حياة متجددة من خلال ربطها بالعروض الفنية الحية المستلهمة من مصر القديمة. وضرورة دفع الاهتمام ذاته في الفنون التعبيرية المصرية وعلى رأسها السينما والدراما التلفزيونية في هذا الاتجاه.
جدير بالذكر أن المصري العبقري نجيب محفوظ بدأ مشروعه الروائي بثلاثية مصرية قديمة هي عبث الأقدار 1939، ورادوبيس 1943، وكفاح طيبة 1944، وكان يود أن يكتب التاريخ المصري القديم كله في مشروعه الإبداعي، لولا أن جذبته اهتمامات أخرى مهمة كانت ملهمة لعالمه الروائي الثري، وقد عاوده ذلك الاهتمام مرة أخرى عندما كتب عام 1985 روايته العائش في الحقيقة عن أخناتون، عندما لاحظ تصاعد الرؤية الوهابية الكارهة لحضارة مصر القديمة، والتي أدمجت نفسها قسرًا وبهتانًا في التفسير الخاطئ لمصر القديمة.
هذا ولا يهمني عبث مثل دراسات الحمض النووي لإثبات أننا أحفاد المصريين القدماء، ملامحنا تقطع بذلك في مجملها عندما نقارن أنفسنا بملامح هؤلاء المصريين القدماء في النقوش والتماثيل والصور.
لغتنا العامية المصرية وما تحمله من ألفاظ هيروغليفية حية في حياتنا اليومية تقطع بذلك.
لسنا في باب الدفاع عن أنفسنا فقط علينا الاهتمام بتدريس اللغة الهيروغليفية في مدارسنا. وزيادة مقرر دراسي إلزامي في كل مراحل التعليم عن الحضارة المصرية القديمة.
واستظهارها في حياتنا اليومية في استلهام ملابسها الممكن وأدوات زينتها وفي تخطيط واجهات المحال العامة، وفي أسماء الشوارع والمباني الاعتبارية، وما إلى ذلك من أعمال تعيد حل إشكاليات تاريخية متعلقة بسؤال الهوية.
إنها المعرفة الحقة المتصلة التي يجب أن ندعمها بكل الطرق بين الأحفاد والأجداد المصريين القدماء.
إنها إجابة الفخر والعز والمستقبل عن سؤال الهوية المصرية.